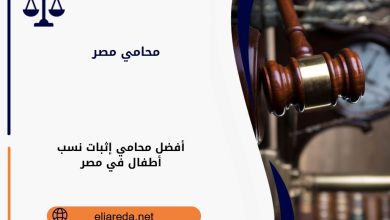استشارات قانونيه
جرائم الإشتباه
جرائم الإشتباه
جرائم الإشتباه :-
بحث قانوني حول وضع نظرية عامة لجرائم الاشتباه
دفعني إلى هذا البحث ما نلاقيه نحن المشتغلين بالقانون من صعوبات كثيرة في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (98) لسنة 1945
فيما يتعلق بجرائم الاشتباه، فلقد ذهبت المحاكم المختلفة في تفسيره وتطبيقه مذاهب شتى يختلف كل منها عن الآخر تمام الاختلاف
ولا تربط أحكامه روابط معينة يمكن تجميعها لاستخلاص قواعد محددة يُعتمد عليها في تفسير نصوص هذا المرسوم
بقانون اللهم إلا أحكام مفرقة أصدرتها محكمة النقض المصرية وضمنتها مبادئ معينة يجوز الاعتماد عليها في وضع نظرية عامة لجريمة الاشتباه في القانون المصري.
وبعد، فقد نصت المادة (5) من هذا المرسوم بقانون على أنه:
(يعد مشتبهًا فيه كل شخص يزيد سنه على خمس عشرة سنة حُكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم الآتية
أو اشتهر عنه لأسباب مقبولة بأنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم):
1 – الاعتداء على النفس أو المال أو التهديد بذلك.
2 – الوساطة في إعادة الأشخاص المخطوفين أو الأشياء المسروقة.
3 – تعطيل وسائل المواصلات أو المخابرات ذات المنفعة العامة.
4 – الاتجار بالمواد السامة أو المخدرة أو تقديمها للغير.
5 – تزييف النقود أو تزوير أوراق النقد الحكومية أو أوراق البنكنوت الجائز تداولها قانونًا في البلاد أو تقليد أو ترويج شيء مما ذُكر).
وواضح من هذا النص أن المشرع قد قصد أن يضع تعريفًا للشخص الذي يُعتبر مشتبهًا فيه فحدد جرائم معينة ظاهر من المادة
أنه ذكرها على سبيل الحصر واعتبر الشخص (مشتبهًا فيه) في أحد حالين:
أولاً: إذا حُكم عليه أكثر من مرة في إحدى هذه الجرائم.
ثانيًا: إذا اشتهر عنه لأسباب مقبولة أنه اعتاد ارتكاب بعض هذه الجرائم.
وتثور الصعوبة لأول وهلة عند هذا التعريف، فالمعتاد أن يكون الركن المادي لأية جريمة فعلاً محددًا سواء كان فعلاً إيجابيًا
أو فعلاً سلبيًا (امتناعًا) فيقال مثلاً السرقة هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بقصد امتلاكه
وجريمة الامتناع عن الشهادة تقوم بامتناع الشاهد عن الحضور للأداء بشهادته أمام القاضي.
أما في تعريف المشرع للشخص المشتبه فيه أو بمعنى آخر تعريفه لجريمة الاشتباه فقد أورد النص حالين هما:
1 – الحكم على الشخص أكثر من مرة.
2 – الشهرة باعتياده ارتكاب بعض هذه الجرائم المحددة.
وليس (الحكم) أو (الشهرة) فعلاً محددًا يرتكبه المجرم فيعاقب عليه، هذه الصعوبة في رأينا هي الصعوبة الأساسية
التي تتفرع منها وتقوم عليها الصعوبات العملية في تطبيق هذا التشريع.
فمن الأسئلة التي يثيرها هذا النص…
متى تقوم هذه الجريمة ؟.. هل بمجرد أن يُحكم على شخص أكثر من مرة في إحدى هذه الجرائم المعينة..
وهل تقوم الجريمة إذا حُكم عليه مرة في جريمة من المنصوص عليها في البند الأول مثلاً وفي أخرى من المبينة في البند الرابع من المادة الخامسة.
– هل تشترط مدة معينة يُحكم على الشخص خلالها أكثر من مرة لكي يُعتبر مشتبهًا فيه ؟
– متى تسقط هذه الجريمة بمضي المدة ؟
– أي المحاكم تختص محليًا بنظر الدعوى عن هذه الجريمة ؟ هل المحكمة التي أصدرت أيًا من الأحكام التي سبق صدورها
ضد المتهم أم المحكمة التي أصدرت آخر حكم عليه أم هل هي المحكمة التي يقيم المتهم بدائرتها ؟
– هل تقوم الجريمة إذا كان الحكم الأول الصادر ضد هذا الشخص قد صدر ضده قبل صدور هذا المرسوم بقانون؟
– في أية صورة يتحقق العود لحالة الاشتباه إن كانت الجريمة نفسها لا تقوم إلا بصدور أكثر من حكم على المشتبه فيه ؟
– ما معيار هذه الشهرة وما المقصود بالأسباب المقبولة المنصوص عليها في تلك المادة ؟
هل هي شيء آخر يختلف عن صدور أحكام كثيرة على هذا الشخص المراد نسبة الجريمة إليه ؟
… وأسئلة أخرى كثيرة لا نجد الإجابة الشافية لها عند مجرد النظر إلى هذا النص سالف الذكر.
واعتقد أنه من الممكن أن نهتدي إلى إجابة لكل من هذه الأسئلة وغيرها لو أمكن تحديد نوع جريمة الاشتباه
أي لو استطعنا وضعها في فصيلة من الفصائل التي جرى شراح القانون الجنائي على أن يقسموا الجرائم إليها
فإن نوع كل جريمة هو الذي يحدد وضعها من القانون الجنائي ومن قانون الإجراءات الجنائية.
يقسم فقهاء القانون الجنائي الجرائم بالنظر إلى ركنها المادي إلى:
1 – جرائم إيجابية وجرائم سلبية.
2 – جرائم وقتية وجرائم مستمرة.
3 – جرائم بسيطة وجرائم عادية.
4 – جرائم مادية وجرائم شكلية.
فما وضع جريمة الاشتباه بالنسبة لهذا التقسيم ؟
يُحسن قبل أن نحاول إدراج جريمة الاشتباه في إحدى الأنواع السابقة أن نبين أهمية هذه المحاولة في حل المشكلات
التي تصادفنا عند تطبيق مواد الاشتباه في العمل والتي أشرنا إلى بعض منها فيما سبق.
فالقول بأن جريمة الاشتباه من الجرائم الوقتية أو المستمرة يضع لنا حدًا للمشكلات التي تصادفنا عند بحث انقضاء الدعوى الجنائية
فيها بالتقادم إذ في الجريمة الوقتية تبدأ مدة سقوط الدعوى من وقت ارتكاب الجريمة أما في الجريمة المستمرة
فلا يبدأ سريان المدة إلا من وقت انتهاء حالة الاستمرار وكذلك بالنسبة للاختصاص المقرر فإن المحكمة المختصة
بنظر الدعوى في الجريمة الوقتية هي التي وقعت هذه الجريمة في دائرتها دون غيرها أما في الجريمة المستمرة
فالأصل أن تختص بنظرها جميع المحاكم التي قامت في دائرتها حالة الاستمرار – كما تهم هذه التفرقة في بحث قاعدة
قوة الشيء المحكوم فيه فالحكم الصادر في جريمة وقتية لا يمنع من إعادة المحاكمة عن واقعة أخرى من نفس النوع الذي حُكم فيه
تكون قد وقعت قبل رفع الدعوى أما الحكم الصادر في جريمة مستمرة فهو يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة لجميع الوقائع التي شملتها حالة الاستمرار قبل رفع الدعوى.
وكذلك الحال عند القول بأن جريمة الاشتباه من الجرائم البسيطة أو من جرائم العادة إذ تشبه جريمة الاعتياد الجريمة المستمرة
في القواعد المقررة بالنسبة للاختصاص والتقادم وحجية الشيء المحكوم فيه.
فهل من الممكن أن نضع جريمة الاشتباه في نوع معين من أنواع الجرائم التي أشرنا إليها ؟
أن تقسيم الجرائم كما أسلفنا يتصل بركنها المادي والركن المادي لجريمة ما يستخلص من صياغة النص بها
ولذا يتعين الرجوع إلى نص المادة الخامسة من قانون الاشتباه لاستخلاص هذا الركن المادي.
تُعرف المادة الخامسة المشتبه فيه بأنه الشخص الذي حُكم عليه أكثر من مرة… والشخص الذي اشتهر عنه أنه اعتاد… إلخ.
والحكم والشهرة أمران لا دخل لنشاط الجاني مباشرةً فيهما فالحكم يصدر من القاضي والشهرة تقوم لدى الناس
ولا دخل للجاني في إذاعتها – فكأن الجاني يعاقب عن أمر لا يقوم مباشرةً بارتكابه وإنما يرتكب نوعًا معينًا من الجرائم فيحكم عليه فيها

أو لا يحكم عليه وإنما يذيع عنه أنه معتاد ارتكابها – ففي الحالة الأولى يلقى الجاني جزاءين – جزاء يوقع عليه
بالحكم عليه في الجرائم التي يرتكبها وجزء آخر يوقع عليه باعتباره مشتبهًا فيه بسبب صدور تلك الأحكام ضده –
وفي الحالة الثانية يكون الجاني قد أفلت من العقاب على الجرائم التي ارتكبها لسبب ما فيلحقه عقاب الاشتباه.
غير أننا نلاحظ أنه في الحالة الأولى يلقى الجاني جزاءين عن فعل واحد ارتكبه وهو أمر غريب في باب التجريم إذ القاعدة
ألا يحاكم الشخص جنائيًا مرتين عن فعل واحد ارتكبه قد يعاقب الشخص جنائيًا ومدنيًا أو جنائيًا وتأديبيًا لارتكابه
فعلاً مجرمًا ولكن أن يعاقب مرتين بعقوبتين جنائيتين لارتكابه فعلاً واحدًا فهو أمر يدعو إلى التساؤل.
ينبغي إذا أن نفسر هذا الأمر تفسيرًا يفصل بين جريمته الأولى وجريمته الأخيرة فلا يكون الركن المادي في الجريمة
التي ارتكبها الجاني في أول الأمر هو بذاته الركن المادي لجريمة الاشتباه فلا نقول مثلاً إن الركن المادي في جريمة الاشتباه
هو بذاته فعل السرقة الذي ارتكبه الجاني مرتين فُحكم عليه مرتين فصار مشتبهًا فيه.
ويتعين علينا عندئذٍ ألا نخوض فيما هو أبعد من النص للوصول إلى النشاط الغير مباشر التي قام به الجاني ولكن يجب
أن نعترف بأن المشرع قد خالف القاعدة العامة المتعارف عليها في تعريف الجريمة وهو وإن اختلفت الصيغ التي
وضعها فقهاء القانون ينحصر في القول بأن الجريمة (كل عمل خارجي إيجابي أو سلبي نص عليه القانون
وقرر له عقوبة جنائية إذا صدر بغير حق يبيحه عن إنسان مسؤول أخلاقيًا).
فالمشرع لم يحرم هذه المرة عملاً ارتكبه الجاني سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا بل حرم صفة قامت لديه هي صفة الاشتباه.
ولكن ما هي صفة الاشتباه، ما تعريفها، ما حدودها وعناصرها وأركانها ؟
تعرفها المادة (5) بأنه الحكم على الشخص أكثر من مرة لارتكابه جرائم معينة أو اشتهار هذا الشخص بأنه اعتاد ارتكاب هذه الجرائم.